علي بن أبي طالب، ابن عم الرسول محمد ﷺ وصهره، ورابع الخلفاء الراشدين، وأحد المبشرين بالجنة، نشأ في كنف النبي ﷺ، وأسلم صغيرا قبل أن يبلغ الحلم، وكان من أوائل من أسلم، نافح عن الإسلام صغيرا وشابا وكهلا، وشارك في غزوات الإسلام الكبرى، عُرف بالشجاعة وتوقد الذكاء والفقه بأمور الدين والحكمة.
إبان خلافته نقل عاصمة الدولة الإسلامية من المدينة المنورة إلى الكوفة، وقد استغرقت عهدَه الفتنُ على إثر مقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان، فحارب الخوارج والسبئية، وقُتل على يد عبد الرحمن بن ملجم الخارجي سنة 40 هـ.
المولد والنشأة
ولد علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي أبو الحسن، في شعب بني هاشم بمكة قبل البعثة بـ10 سنين وقبل الهجرة بـ23 عاما.
ووالده أبو طالب (واسمه عبد مناف) سيد من سادات قريش آل إليه شرف السقاية والرفادة بعد وفاة والده (جد علي) عبد المطلب، وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم التي شاركت زوجها في تربية النبي ﷺ بعد وفاة جده، وقد كانت سيدة من سيدات بني هاشم اللواتي يشار إليهنّ بالبنان.
كفله النبي الكريم ﷺ بعد أن أصاب قريشا قحطٌ شديد أورث الناس جوعا وفقرا، وكان أبو طالب كثير العيال، فأراد النبي عليه السلام أن يخفف عن عمه بعضا من همه، كما أراد من هذه البادرة أن يردّ بعض الجميل لبيت عمه الذي نشأ فيه، وكان دَيدَنُه المسارعة إلى مكافئة من يحسن إليه قال ﷺ: "ما لأحد عندنا يدٌ إلا وقد كافأناه، خلا أبا بكر".
ومنذ أن بلغ السادسة من عمره أقام علي في بيت ابن عمه محمد ﷺ فتفتح وعيه في بيت من أنبل بيوت قريش المشهود لها بالفضيلة والخلق الرفيع وحسن السيرة في الناس، بعد أن تشرّب موروثات العرب الكريمة في بيت أبيه سيد قريش ووريث بني هاشم.
وظل علي منذ أن دخل بيت النبي الكريم مرافقا له لم يبرحه إلا لمهام يكلفه بها -عليه الصلاة والسلام- زهاء 17 عاما في مكة، و10 أعوام في المدينة المنورة. إسلامه
ولم يلبث الفتى بعد أن دعاه ابن عمه إلى الدين الجديد حتى آمن به وصدقه، فكان أول الفتيان إسلاما، وكان إذ ذاك بعمر العاشرة.
وقد اختلف الرواة فيمن أسلم أولا، غير أن أرجح الآراء مستقرة على أن أولهم من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومن النساء خديجة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، ومن الفتيان علي بن أبي طالب.
هجرته إلى المدينة
عُرف علي بالشجاعة والإقدام منذ نعومة أظفاره، وكان محبا للنبي الكريم، فلم يتردد وهو فتى يناهز الـ20 من عمره بالنوم في فراش رسول الله ﷺ ليلة الهجرة، وكان المشركون يتربصون بالنبي ليقتلوه في فراشه.
وبقي عليّ آخر الناس هجرة إلى المدينة بأمر من رسول الله حتى يردّ إلى الناس ودائعهم التي كانوا يستأمنون عليها النبي الكريم ﷺ، ويخرجَ بأهله من مكة إلى المدينة، فخرج علي يمشي بالليل ويكمن في النهار، حتى قدِم المدينة، فلما بلغ النبيَّ عليه الصلاة والسلام نبأُ وصوله، دعاه إليه، فأخبره الناس أن عليا لا يستطيع المشي، فأتاه النبي ﷺ واعتنقه باكيا لِما رأى بقدمَيه من الورم جراء المشي أياما، فمسح النبي الكريم بيديه الشريفتين على قدميه، فلم يشتكهما حتى استشهد.
زواجه من السيدة فاطمة الزهراء
توالى عدد من الصحابة لخطبة الزهراء بنت النبي عليه الصلاة والسلام، وفيهم أبو بكر وعمر، غير أن النبي ﷺ ردهم جميعا لصغر سنها، حتى تقدم لخطبتها علي بن أبي طالب فزوجها منه بعد معركة بدر (السنة الثانية للهجرة) وكان عمرها حينذاك 15 سنة بينما كان عمر علي 25 سنة.
ولم يتزوج علي على فاطمة في حياتها رغم من أن التعدد كان منتشرا في عهد الصحابة، وقد كان الواحد منهم يجمع أكثر من امرأة في ذمته، غير أن كرامة بنت النبي ﷺ منعته من ذلك، ولما عزم بعد فتح مكة على الزواج من ابنة أبي جهل منعه النبي ﷺ من ذلك إلا أن يطلق فاطمة، فعدل عن رأيه وثنى من عزمه.
وقد أنجبت فاطمة له السبطين، الحسن والحسين، ومنها رضي الله عنها امتد نسل النبي ﷺ دون غيرها من أبنائه وبناته. بعض مآثره في حياة النبي ﷺ
شارك علي بن أبي طالب في جميع غزوات النبي ﷺ إلا غزوة تبوك، حيث استخلفه على المدينة في غيابه، ولما أثار المنافقون أن النبي ﷺ ما خلّف عليا إلا لشيء كرهه منه، تبعه علي يسأل عن سبب إبقائه إياه في المدينة، فقال له النبي الكريم "يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟"، فقال علي: "رضيتُ.. رضيتُ".
وفي العام التاسع للهجرة ولى النبي ﷺ أبا بكر إمارة الحج، فحج في الناس، وأعلن "أنه لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان"، وبعث معه عليا بسورة براءة (التوبة) ليقرأها على الناس في الموسم.
وفي العام نفسه جاء إلى النبي ﷺ وفْدُ أهل اليمن، فبعث معهم خالد بن الوليد، فأقام فيهم 6 أشهر يدعوهم فلم يجيبوه، فأوفد إليهم عليا، فدعاهم فأسلموا، فكتب للنبي ﷺ يخبره، فخرَّ عليه الصلاة والسلام ساجدا يقول: "السلام على همدان، السلام على همدان". وكان علي حينها يناهز الـ32 من عمره.
وفي حجة الوداع رافق النبيَّ ﷺ وكان معه 100 من الهدْي فنحر ﷺ 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما بقي منه وأشركه في هديه.
مواقفه في ميادين الحرب
كان علي رضي الله عنه من الثلاثة الذين انتدبهم النبي ﷺ لمبارزة رؤوس قريش في غزوة بدر الكبرى، كما أعطاه الراية يوم أحد (عام 3 هـ) بعد استشهاد مصعب بن عمير، وهو من الذين ثبتوا حول النبي ﷺ بعد نزول الرماة من الجبل وإحاطة خالد بن الوليد بجيش المسلمين.
وفي غزوة الخندق (عام 5 هـ) برز علي للفارس المشهور عمرو بن عبد ود، الذي كان يقوَّم بألف فارس فبارزه وقتله.
وقد أظهر علي في الحديبية أدبه الجم وحبه العظيم للنبي ﷺ، فلما صالح رسول الله قريشا في الحديبية كتب علي بين الطرفين كتابا (وكان علي من كتّاب رسول الله ﷺ): "هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله ﷺ"، فقال ممثلو قريش في الصلح: لا نقرّ بها، فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك، لكن أنت محمد بن عبد الله، فقال لعلي: "أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله، امحُ رسول الله"، فقال علي: لا والله لا أمحوك أبدا، فقال رسول الله: "فأرنيه" فأراه إياه، فمحاه النبي ﷺ بيده.
وفي العام السابع للهجرة عزم النبي ﷺ على غزو خيبر آخر معاقل اليهود في جزيرة العرب، وكانت أمنع ما تكون من القلاع، فاستعصت على المسلمين أياما، حتى قال النبي ﷺ: "لأعطينّ الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحبّ اللهَ ورسولَه، ويحبه اللهُ ورسولُه"، فتطلع جميع الصحابة لهذه المكانة، ولما كان من الغد سأل النبي ﷺ عن علي فقيل له إنه يشتكي عينيه، فأرسل إليه، وبصق ﷺ فيهما، ودعا له فبَرَأ حتى كأن لم يكن به وجع، ثم أعطاه الراية وأوصاه.
وقد لقي علي في هذه الغزوة أكبر فرسان خيبر مرحب اليهودي وكان مضرب مثل في قومه بالشجاعة والإقدام، فلقيه علي وقتله. علمه
كان لطول ملازمة علي بن أبي طالب للنبي ﷺ أثر كبير في تكوينه العلمي، إضافة إلى ما وهب من قلب عَقول ولسان سؤول كما وصف نفسه، وقد روى عن النبي ﷺ زهاء 600 حديث، وهو أكثر من مجموع ما رواه الخلفاء الراشدون الثلاثة الآخرون مجتمعين، وحدّث عنه جمع كبير من الصحابة والتابعين.
كما قرأ علي القرآن على النبي ﷺ وحفظه في حياته، قال عنه أبو عبد الرحمن السلمي -وهو ممن عرض القرآن على علي-: ما رأيت أحدا كان أقرأ من علي.
وكذلك اهتم علي بتفسير كتاب الله تعالى، روى ابن سعد في الطبقات أن عليا قال: "سلوني عن كتاب الله فإنه ليس من آية إلا وقد عرفت بليل نزلت أم بنهار، في سهل أم في جبل".
وقد امتلأت كتب التفسير بمرويات الإمام علي في تفسير القرآن وإبداء الرأي في تأويله.
ويعد علي بن أبي طالب من أكابر فقهاء الإسلام، وقد كان من الصحابة الذين أفتوا في حياة النبي ﷺ.
وروى ابن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا قال: "أقرؤنا أبي (بن كعب) وأقضانا علي"، وقال ابن مسعود: "كنا نتحدث أن أقضى أهل المدينة علي بن أبي طالب". وكان النبي ﷺ قد أرسله إلى اليمن داعيا وقاضيا.
فصاحته
اتفقت كلمة الأدباء على أن علي بن أبي طالب عَلَم من أعلام البلاغة وإمام من أئمة الفصاحة، وقد أثرى أسلوبَه الخطابي تشبّعُه من القرآن الكريم والبيان النبوي الرفيع، فضلا عما لسليقته العربية التي ارتوت من معين فصاحة الأعراب وبلاغة أهل مكة من فضل وأثر.
وكثيرا ما كان يضمّن في خطبه وشعره التعبير القرآني والمفردة النبوية والمثل السائر البليغ، حتى صار موروثه الأدبي مطلبا لكل طالب أدب وبلاغة على مر الدهور.
ومن النماذج العالية من مواعظه، قوله بعد أن صلى بالناس الفجر: "لقد رأيت أصحاب رسول الله ﷺ فما أرى أحدا يشبههم.. والله لقد كانوا يصبحون شُعْثا غُبرا صُفرا، بين أعينهم مثل رُكَب المِعزى، قد باتوا لله سجّدا وقياما، يتلون كتاب الله يراوحون بين جباههم وأقدامهم، فإذا أصبحوا فذكروا الله مادوا كما تميد الشجرة في يوم ريح، وهملت أعينهم حتى تبُلّ والله ثيابهم..". فضائله ومكانته
لم تتعرض شخصية من شخصيات الصحابة لما تعرض له علي من التشويه والمغالاة والكذب والافتراء، فكثرت في سيرته الروايات المكذوبة والأخبار التالفة التي نسبت له الخوارق، أو ألصقت فيه من الصفات والمناقب ما ليس له، أو وضعت على لسانه ما لم يقله، فزعم بعضها الوصية له، وأنه وارث علم النبوة، ومفتاح مدينة العلم، وأن الحق يدور معه حيث دار، وأن ذكره عبادة، وحبه حسنة لا تضر معها سيئة، وغير ذلك من الأساطير والأباطيل التي لا تقوم على نقل صحيح ولا دليل صريح.
غير أن المسلمين يعرفون لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب مكانته الرفيعة، فقد كان من أحب صحابة رسول الله ﷺ إليه، وهو ابن عمه، نشأ في بيته، وأصهر إليه على أحب بناته، كما كان من العشرة المبشرين بالجنة، ولقد قربه النبي ﷺ وأدناه وألقى عليه الكساء ودعا له، ونهى عن مشاققته والإساءة إليه.
وفي مكانة علي من النبي ﷺ أحاديث صحيحة كثيرة، منها قوله لعلي: "أنت مني وأنا منك"، وكذلك لما أخذ بيده وقال له: "من كنت وليّه فهذا وليّه، اللهم والِ من والاه، وعادِ من عاداه".
ولما غاضب علي زوجته فاطمة، وترك البيت وأوى إلى المسجد، ذهب إليه النبي ﷺ وكان مضطجعا قد سقط رداؤه عن شقه، وأصابه تراب، فجعل رسول الله ﷺ يمسح عنه ويقول: "قم أبا تراب، قم أبا تراب".
خلافته
ما إن استشهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان ونفض الناس أيديهم من دفنه حتى سارعوا إلى علي يريدون مبايعته بالخلافة، وقد أراد رضي الله عنه التملص من الأمر، ولما لم يجد بدًّا أحال أمر البيعة إلى أهل السابقة من المهاجرين والأنصار، فدفعوه إلى ذلك، غير أنه اشترط أن تكون في المسجد النبوي على رؤوس أهل المدينة، فقدِم المسجد وبايعه الناس، وكان ذلك في 18 من ذي الحجة عام 35 هـ. وقد كان ابن عباس يريد أن تكون البيعة في مكان خاص مخافة أن يَشْغَب على الحدث الثائرون على عثمان، وكانوا منتشرين في أزقة المدينة لا يبرحونها.
استلم علي مقاليد الخلافة وهي مثقلة بالأعباء، وفي خضم فتنة من أكبر الفتن التي واجهت المسلمين، فقد واجه رفضَ بيعة بعض المسلمين في الأمصار التي أرسل إليها الولاة لأخذ البيعة، حيث كان هؤلاء الرافضون -الذين رأى ابن حزم أن عددهم يساوي عدد من بايع وقدّرهم بـ100 ألف مسلم- يرون ضرورة المسارعة بأخذ الثأر من قتلة عثمان قبل أخذ البيعة لعلي.
وبهذا فإن عليا كان أول خليفة لا يجتمع عليه المسلمون كما اجتمعوا على سابقيه الثلاثة، أبي بكر وعمر وعثمان، يقول ابن تيمية: "كان الناس على عهد علي 3 أصناف: صنف قاتلوا معه، وصنف قاتلوه، وصنف لا قاتلوه ولا قاتلوا معه".
وقد فاقم من هذه الأزمة عوامل منها أن قتلة عثمان كانوا قوةً ولهم شوكة، خصوصا بعد أن انتقل علي بعاصمة الدولة إلى الكوفة، حيث أضحت هذه الفئات في معقلها وبين قبائلها، وتغلغلت في صفوف مؤيدي علي، وصار لها تأثير بالغ في القرار السياسي، فصار من العصي على علي وغيره أن يكسر شوكتهم.
وقد أسفر هذا الخلاف عن تهتك أصاب النسيج الاجتماعي في المدينة وما حولها، وزاد من تفاقم الأمر اعتزال كبار الصحابة العملَ السياسي الذي وصفوه بالفتنة، ومن هؤلاء سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وأسامة بن زيد وأبو موسى الأشعري.
وقد أدى هذا الانشعاب الحاصل في وحدة المسلمين والصدع الكبير الذي فرّق الرأي إلى تفرّق المقاتلين في الأمصار، مما أضعف القوة العسكرية الإسلامية التي كانت قادرة على حسم الخلاف لو بقيت مجتمعة.
كما كان من نتيجة هذه الفتن المستعرة أن تقلصت مساحة سلطة أمير المؤمنين على الولايات واحدة إثر أخرى، بعد أن اضطربت عليه الشام واليمن والحجاز ومصر، وخرجت البصرة وخراسان من قبضته، فانحصر حكمه في الكوفة وما حولها بعد انتقاله إليها. الفتن في فترة خلافته
مِن نار فتنة مقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان استطار شرر الفتن التي استعرت واستغرقت خلافة علي بن أبي طالب بكاملها، وقد انشعب الصحابة وتفرّق رأيهم تحت وطأة آثارها الثقيلة، ففريق أراد المسارعة إلى أخذ الثأر من قتلة عثمان رغم مبايعتهم عليا، وكان الخلاف بينهم وبين علي على توقيت الثأر، فالخليفة يريد أن يبسط سلطانه على الدولة ويحكم أمره فيها قبل مباشرته أخذَ الثأر، وهم يرون أنه لن يستطيع ذلك حتى يبدأ بالقضاء على القتلة وإنهاء وجودهم في المدينة وتهدئة نفوس المسلمين وأولياء الدم من بني أمية بإنفاذ القصاص.
وكان على رأس هذا الفريق الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وعائشة أم المؤمنين الذين خرجوا من المدينة إلى مكة فاجتمعوا بها مع آخرين، ثم عزموا المسير إلى البصرة ليستقووا بأهلها على الخوارج السبئية الذين قتلوا عثمان وانتشروا في المدينة وأثروا في قرارها السياسي وأوهنوا قوة علي واخترقوا جيشه.
وكان معاوية والي عثمان على الشام وبنو أمية أبناء عمومة الخليفة المغدور وأولياء دمه، قد رفضوا البيعة حتى تنتهي قضية عثمان، فخرج إليهم علي يريد ردّهم عن خروجهم وإلزامهم البيعة التي بايعه عليها المسلمون، غير أن أخبار خروج طلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة إلى البصرة غيرت وجهته، فسار إلى البصرة ولم يكن في نيته سوى الإصلاح، ولما وقف خطيبا في الكوفة يستنفر أهلها للخروج معه، قال: "وقد دعوتكم لتشهدوا معنا إخواننا من أهل البصرة، فإن يرجعوا فذاك ما نريد، وإن يلجّوا داويناهم بالرفق وبايناهم حتى يبدؤونا بظلم، ولن ندع أمرا فيه صلاح إلا آثرناه على ما فيه الفساد إن شاء الله". وقد أرسل القعقاعَ بنَ عمرو إلى طلحة والزبير، فقال له: "القَ هذين الرجلين، فادعهما إلى الألفة والجماعة، وعظّم عليهما الفرقة".
والأخبار الصحيحة متواترة بنية الطرفين لزوم الإصلاح وانتفاء الرغبة في الاقتتال، ولما حضر القعقاع مجلس أم المؤمنين عائشة في البصرة وفيه طلحة والزبير عرض عليهم رأيه في الصلح وجمع كلمة المسلمين ووحدة صفهم قبلوا منه ورضوا بما قال، فعاد إلى علي، فاغتبط بما حصل وتجهز للرحيل، غير أن المندسين في صفوف جيشه من الرعاع والسبئية أيقنوا أن الصلح بين الطرفين سيوجه السيوف إلى نحورهم ويمكّن الخليفة من إقامة القصاص عليهم، وقد قال الأشتر النخعي وهو من رؤوس قتلة عثمان: "فإن كان قد اصطلح (يعني عليا) معهم (يعني طلحة والزبير ) فإنما اصطلحوا على دمائنا".
فتواطأ قتلة عثمان على بدء القتال فحملوا على معسكر طلحة والزبير، فظن طلحة والزبير أن عليا حمل عليهم وأخل بالاتفاق، فدافعوا عن أنفسهم وهاجموا معسكر علي، فظن علي أنهم حملوا عليه وأخلوا بالاتفاق، فوقع القتال ولم يتوقف إلا بعد أن سالت دماء غزيرة. قال الطحاوي: "فجرت فتنة الجمل من غير اختيار من علي ولا من طلحة والزبير".
ولم يكد ينطفئ لهيب هذه الفتنة حتى استعر أوار فتنة أخرى في الشام، وكما كان وراء الأولى أيادي العابثين من السبئية فقد كانت أياديهم تقدح الزناد لتوري الثانية، يقول الطبري: "وأعجلت السبئية عليا عن المقام، وارتحلوا بغير إذنه، فارتحل في آثارهم ليقطع عليهم أمرا إن كانوا أرادوه". ولما علم معاوية بتحرك علي نحو الشام تجهز وخرج بنفسه على رأس جيشه، ورغم تحرك السفارات بين الفريقين فإن الأمر لم يسر على وفاق بينهما، فقد أصر علي على أخذ البيعة من معاوية وأصر معاوية على تنفيذ القصاص من قتلة عثمان قبل بيعة علي.
ثم نشب القتال بين الطرفين في مكان يدعى صفين (قرب مدينة الرقة السورية) ودارت رحى الحرب أياما كانت بينهم سجال، حتى توجهت الغلبة لجيش العراق على جيش الشام، فأشار عمرو بن العاص على معاوية أن يرفعوا المصاحف على أسنة الرماح، ويقولوا: هذا بيننا وبينكم.. قد فنيَ الناس.. فمن للثغور؟ ومن لجهاد المشركين والكفار؟
ثم قال عمرو لمعاوية: "أرسل إلى علي بمصحف فادعه إلى كتاب الله فإنه لن يأبى عليك"، فقال علي: "نعم، أنا أولى بذلك.. بيننا وبينكم كتاب الله".
ولما قبل الفريقان التحكيم، اختار أهل العراق أبا موسى الأشعري واختار أهل الشام عمرو بن العاص ممثلين كل عن فريقه للصلح بين الطرفين، فتوافقا على "أن يحكما بين هذه الأمة ولا يرداها في حرب ولا فُرقة حتى يعصيا"، وأطالت وثيقة التحكيم أجل اجتماع الحكمين مدة 8 أشهر لتهدأ النفوس وتحدث المراجعة والنظر في عواقب الخلاف.
وفي رمضان من عام 37 هـ اجتمع الحكمان في دُومة الجندل، واتفقا على أن يُترك النظر في أمر الخلافة إلى أكابر الصحابة وشورى المسلمين، ولم يُحسم الخلاف بين الفريقين بسبب صعوبة الحل بشأن المسألتين المختلف عليهما: بيعة أهل الشام للخليفة، وإقامة الحد على قتلة عثمان، وبقي الحال على ما كان عليه قبل القتال، فكانت العراق والحجاز لعلي، وكانت الشام وما حولها لمعاوية.
غير أن أظهر ما نتج عن صفين وواقعة التحكيم تضعضع جيش أمير المؤمنين علي، حيث خالفه السبئية وقتلة عثمان رفضا لنتائج التحكيم، وخرجت عليه طائفة القراء (الخوارج) الذين قالوا بوجه علي: "لا حكم إلا لله"، فقال رضي الله عنه: "كلمة حق أريد بها باطل".
أسفرت واقعة التحكيم عن فتنة جديدة أطلت برأسها في خلافة علي رضي الله عنه، فطائفة القراء الذين كانوا معه اعتزلوه رفضا لما آل إليه الأمر، وقالوا له: "انسلخت من قميصٍ (يقصدون الخلافة) ألبسكه الله، واسمٍ (يعنون لقب أمير المؤمنين) سمّاك الله به، ثم انطلقت فحكّمت في دين الله، فلا حكم إلا لله".
وأرسل إليهم لما شغبوا على الناس وأثاروهم، عبدَ الله بن عباس يحاججهم في كتاب الله، فعاد عن رأيه منهم 4 آلاف وبقي مثلهم على رأيهم.
وظل علي بهم يروادهم عن آرائهم حتى ضاق بهم، وقد ألّبوا عليه الناس، فاجتمعوا بالنهروان (موقع شمال بغداد) وصارت لهم شوكة ومنعة، وعاثوا في الأرض فسادا، وسفكوا الدماء وقطعوا السبيل. فتوجه إليهم علي بجيشه في شعبان سنة 38 هـ. ولم يبدأهم بقتال حتى بدؤوه، فقاتلهم وقتلهم ولم ينج منهم إلا عدد قليل. استشهاده
اتفق بعض ذوي القتلى من الخوارج الذين أنام علي فتنتهم على الثأر لذويهم، فتعاهد 3 نفر كان منهم عبد الرحمن بن ملجم على قتل علي ومعاوية وعمرو بن العاص.
سار ابن ملجم إلى الكوفة لتنفيذ ما اتفق عليه مع صحبه، فترصد لأمير المؤمنين في المكان الذي يخرج منه عادة وقت الفجر لإيقاظ الناس للصلاة، وكان ذلك في رمضان سنة 40 هـ.
ولما خرج من بيته ينادي في الناس الصلاةَ الصلاةَ، ثار إليه ابن ملجم وضربه بسيفه فأصاب جبهته وأسال دمه على لحيته، فمكث رضي الله عنه يوم الجمعة وليلة السبت وفاضت روحه إلى بارئها ليلة الأحد، ودفن بدار الإمارة في الكوفة.
واستمرت خلافته 4 سنين و9 أشهر وكان عمره يوم استشهد 63 سنة.
المصدر : الجزيرة
- الصفحة الرئسية
- المدونة
- تسجيل الدخول
- الدروس
- تواصل معنا
- حول EDUCTRIP
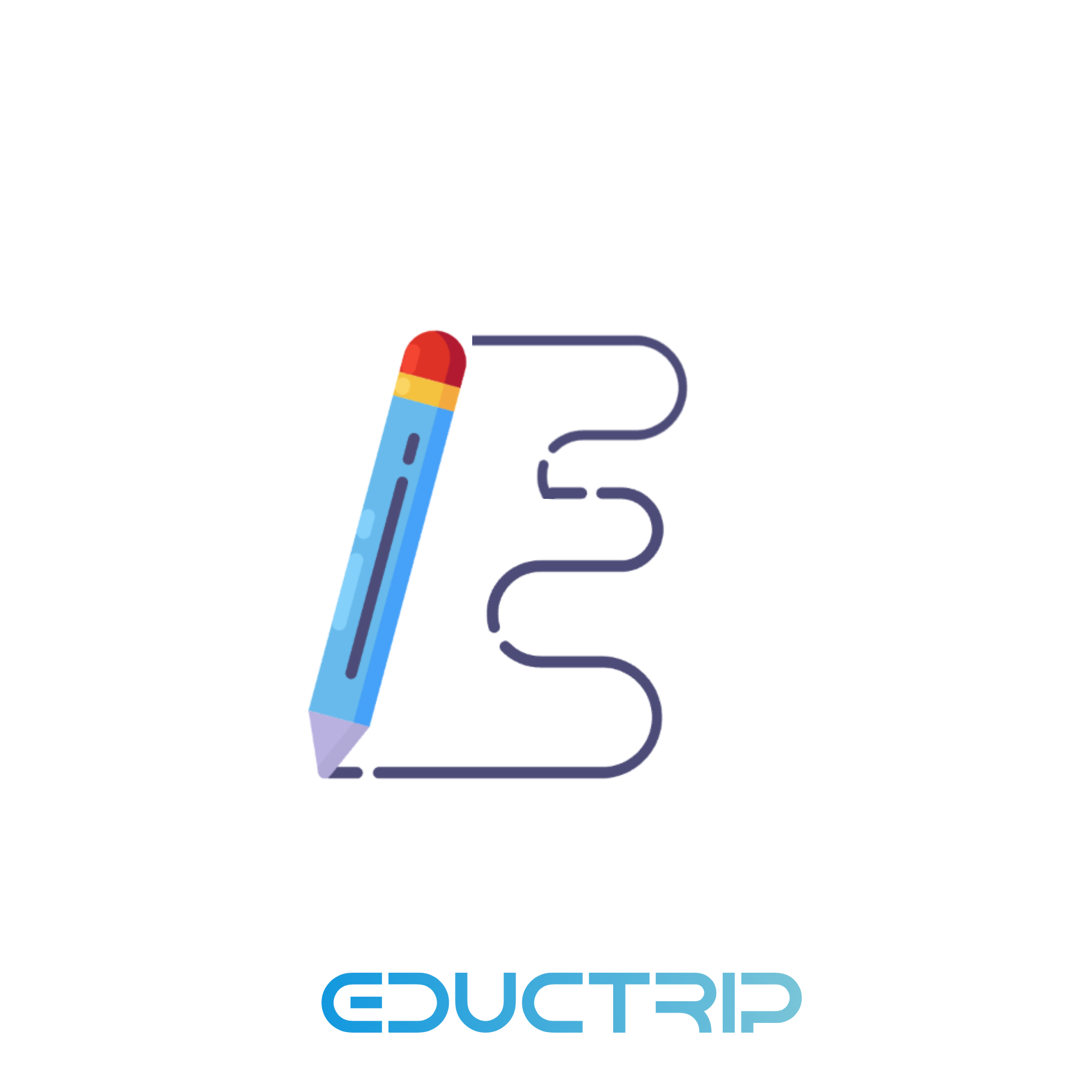
مواقع التواصل الجتماعي



.jpg)
